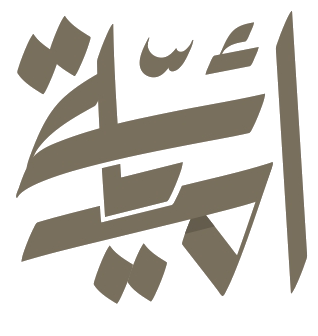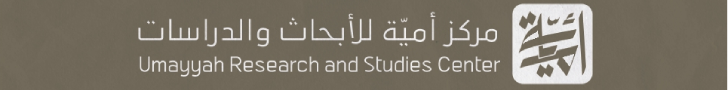(تحليل حضاري لمعادلة الوحدة والتنوع)

مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_تحليل_سياسي_أحمد_الحاجي_مؤتمر_الحسكة_ومأزق_الفكرة_الجامعة_تحليل_حضاري_لمعادلة_الوحدة_والتنوع
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها سوريا، تتجلى أهمية الحوار والتفاهم بين مكوناتها المختلفة. مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” الذي عُقد في مدينة الحسكة في أغسطس 2025، يُعتبر نقطة انطلاق جديدة للمساعي الرامية إلى تحقيق التلاحم الوطني. ومع ذلك، يُثير انعقاد هذا المؤتمر في وقتٍ يتسم بالتوتر الإقليمي تساؤلات حول أهدافه الحقيقية وآثارها المحتملة. يُعَدُّ هذا الحدث تجسيدًا للصراع بين الرغبة في تحقيق التعددية واللامركزية، وبين المخاوف من تزايد الانفصال والتشرذم الذي قديُهدد مستقبل الدولة السورية. إذن، كيف يمكن تحقيق الوحدة في ظل التحديات الحالية؟
مؤتمر الحسكة: خلفيات ودلالات
في الثامن من أغسطس 2025م، شهدت مدينة الحسكة انعقاد مؤتمر بعنوان ’’وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا‘‘ بدعوة من جهات مرتبطة بـ ’’الإدارة الذاتية‘‘ و’’قسد‘‘. ورغم الألفاظ المصقولة عن التعددية واللامركزية، فإن انعقاده في لحظة إقليمية حرجة، بعد عرقلتهم لمسارات الحل السياسي في سوريا، أثار الشكوك حول غاياته ووجهته، خاصة مع تزايد المؤشرات على أنه حلقة في مشروع أكبر يعيد تشكيل الخريطة السياسية بما يخدم أجندات تتجاوز حدود الوطن.
التعددية واللامركزية: بين النظرية والواقع
وهنا يلزم التمييز بين المكوّنات الوطنية الأصيلة التي تسعى لحماية خصوصيتها في إطار الدولة الجامعة، وبين الأقليات السياسية الانفصالية التي تتخذ من شعارات الحقوق والتمثيل ستاراً لتعطيل أي مشروع وطني جامع، وتستقوي بالخارج لتحقيق مكاسب آنية وشخصية ضيّقة، ولو كان الثمن تمزيق النسيج الوطني وإضعاف الدولة(([1] .
الانفصال الشعوري والسياسي: إرث نظام الأسد
ولم يكن هذا الانفصال الشعوري والسياسي وليد اللحظة، بل هو نتاج إرث ثقيل لنظام الأسد – الأب والابن – الذي أرسى نهجاً في الحُكْمِ يقوم على تمزيق النسيج السوري، وإضعاف الانتماء الوطني، خاصة عند الأقليات، من خلال صناعة الولاءات الضيقة وإذكاء الشكوك المتبادلة، واستخدام سياسة ’’فرّق تسد‘‘ كأسلوب ثابت لضبط الداخل. وقد مهّدت هذه السياسة الأرضية لأن تنغلق بعض المكوّنات على نفسها، وتبحث عن حماية خارجية بدل اندماجها في مشروع وطني موحّد، ممّا جعل أي خطاب انفصالي يجد تربة خصبة للنمو.
وكما يقرر ابن خلدون، فإن قيام الدول مشروط بتحوّل العصبية من الانتماء الضيق إلى الانتماء الأشمل الذي يصهر الولاءات في كيان وطني واحد. غير أن ما شهدناه في مؤتمر الحسكة هو ارتداد إلى العصبيات الجزئية – القومية والعشائرية والإثنية – التي تنغلق على ذاتها وتنفصل عن العصبية الوطنية، وهو انكماش حضاري محكوم بالفشل، لأن سنن الاجتماع البشري تحكم بأن التنازع الداخلي يفتح الأبواب لرياح الضعف والفناء. وهكذا تتحوّل العصبية من رافعة لبناء الدولة إلى أداة لتعطيلها، وتغدو ورقة في يد القوى الخارجية.
غياب الفكرة الجامعة: تبعات على الأمن والاستقرار
ومن منظور مالك بن نبي، فإن غياب ’’الفكرة الجامعة‘‘ يترك المجتمع عارياً أمام المشاريع الخارجية، حتى لو لبست لبوس المطالب المحلية. ففي شمال شرق سوريا، أفسح التفكك القومي والطائفي المجال لخطاب الوصاية الدولية و’’الدساتير الخاصة‘‘، ما أوجد في الوعي الجمعي للأقليات السياسية شعوراً بأن الأمن لا يُستمد إلا من الخارج، فيقطع خيط الانتماء ويُدخل الكيان في دوامة تبعية استراتيجية.
استجابة التحديات: بين الإبداع والتفتيت
ويؤكد أرنولد توينبي أن الأمم تتقدم حين تواجه التحديات باستجابات خلاقة، وتنهار حين تنكفئ إلى استجابات تفتيتية. وكان التحدي في شمال وشرق سوريا بعد الحرب أن يُعاد دمج المكوّنات في دولة عادلة، لكن ما قدمه المؤتمر هو حل تجزيئي يحوّل المكونات إلى جزر معزولة تبحث عن حماية أجنبية، وهو المسار نفسه الذي يجعل الهويات الصغرى، متى تحالفت مع الخارج، أداة لإعادة رسم الخرائط لا لحماية الذات.
وفي ميزان الواقعية السياسية، ترى تركيا في أي كيان مسلح ذي طابع قومي كردي على حدودها تهديداً وجودياً، فيما ترى سوريا أن بقاءها مشروط بإعادة بناء المركز وضبط الأطراف.
لكن مثل هذه المؤتمرات تخلق مرجعيات سياسية بديلة تعقّد استعادة التماسك الوطني. ولا يخفى أن بعض مُخرجاتها تتقاطع مع خرائط مراكز أبحاث غربية منذ 2012م لتقسيم سوريا إلى كانتونات قومية وطائفية، بما ينسجم مع ما وصفه بريجنسكي بـ ’’إعادة هندسة الخرائط عبر إدارة الفوضى‘‘.
المشاريع الخارجية وتأثيرها على الهوية الوطنية
إن الانفصاليين وهم يسلكون هذا المسار إنما يقايضون المستقبل بالحاضر، ويستبدلون وحدة الكيان بصفقات مؤقتة، في قصر نظر سياسي يكرر سنن التاريخ في سقوط الكيانات التي فقدت بوصلة مشروعها الجامع. فسنن الله في الاجتماع والعمران تقضي بأن بقاء الأمم مرهون بالوحدة، وأن التنوع إذا لم يُصهر في مشروع حضاري موحّد يتحول إلى معول للهدم.
رؤية حضارية استراتيجية لسوريا الموحدة
إن الرؤية الحضارية الاستراتيجية لسوريا الموحّدة تقتضي الانتقال من إدارة التنوع بوصفه أزمة، إلى استثماره بوصفه رصيداً حضارياً، وإعادة بناء عقد وطني جامع يقوم على العدالة والمواطنة ويستند إلى السنن الإلهية في الاجتماع، ويحقق مقاصد الشريعة في حفظ الأديان، والإنسان والعمران.
على هذا الأساس، يمكن تحويل الجغرافيا السورية من ساحة نزاع إلى فضاء تفاعل حضاري، وتحرير الإرادة الوطنية من الارتهان للأجنبي، وبناء قوة سياسية وثقافية واقتصادية تجعل من سوريا كياناً موحّداً قادراً على حماية أبنائه جميعاً. وهكذا تصبح سوريا نموذجاً في القدرة على الجمع بين الوحدة والتنوع، وبين الأصالة والتجديد، في مشروع حضاري يحفظ السيادة ويؤمن المستقبل.
___________
أ.أحمد الحاجي: كاتب وباحث في السياسية الشرعية.
هذا التحليل السياسي يُعَبِّرُ عن رأي كاتبه ولا يُعَبِّرُ بالضرورة عن رأي الموقع.
-[1] أصدرنا في مركز أمية كتاباً بعنوان ’’مواطنون لا أقليات‘‘ شارك في كتابته شخصيات مرموقة من مكونات النسيج السوري.

مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_تحليل_سياسي_أحمد_الحاجي_مؤتمر_الحسكة_ومأزق_الفكرة_الجامعة_تحليل_حضاري_لمعادلة_الوحدة_والتنوع