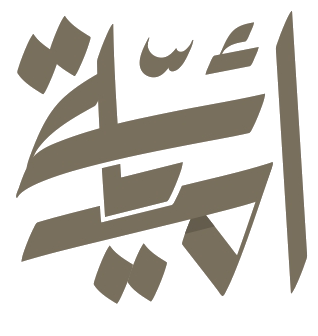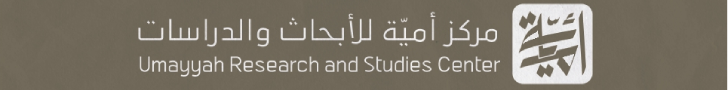(المجاعة أقسى صور السقوط الحضاري)

مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_مقالات_تاريخية_أحمد_الحاجي_قراءة_في_تاريخ_المجاعة_المجاعة_أقسى_صور_السقوط_الحضاري
في خضم الأزمات الإنسانية التي تضرب العالم، تظل المجاعة رمزًا معبرًا عن انهيار القيم الإنسانية وغياب العدالة. فبينما كانت المجاعة في الماضي جرس إنذار لضمائر الشعوب ونقطة تحول في مسارات التاريخ، أصبحت اليوم أداة تستخدمها الأنظمة المستبدة لإخضاع الشعوب وتفكيك المجتمعات. في هذا السياق، يستعرض المقال كيف تحولت المجاعة إلى سلاح سياسي في سورية، حيث جُوّعت المدن الثائرة كوسيلة لفرض السيطرة، مما يسلط الضوء على تجارب تاريخية من الماضي القريب والبعيد.
يربط المقال بين مآسي الجوع في ظل الأنظمة القمعية، وضرورة إحياء قيم النخوة والمروءة التي كانت راسخة في ذاكرة الأمة، مشيرًا إلى أن الحضارة لا تُبنى بالأبنية فحسب، بل تتطلب أيضًا الرحمة والتعاطف مع الضعفاء. من خلال هذه السطور، نستحضر دروس التاريخ ونحث على استعادة القيم الإنسانية التي تُعيد للأمة كرامتها
المجاعة كأداة للسلطة: من أدوات القمع إلى وسائل التجويع
في ذاكرة البشر، كانت المجاعة دوماً جرس إنذار إلهي، أو صفعة أخلاقية، أو علامة على انهيار منظومةٍ بأكملها. لكنها اليوم تحوّلت إلى أداة متقنة في يد الجلادين، لا تهزّ ضميراً، ولا توقظ نخوة، ولا تغيّر شيئًا في مسار الطغيان. لقد صار الجوع في القرن الحادي والعشرين حادثة سياسية أكثر منها نازلة طبيعية، وآلية متعمّدة لصناعة الانهيار.
سورية: الجوع بين الواقع السياسي والتاريخ الثقافي
وحصار الجوع لم يكن وليد الأمس، ففي سوريا، جُوِّعت المدن الثائرة عمداً، واعتُمد التجويع كسلاح رسمي في مخططات النظام البائد. وذاعت صور الأطفال الهزلى في غوطة دمشق ومضايا ودير الزور…مستخدمين سياسة: ’’الجوع أو الركوع‘‘. فلم يكن ذلك مجرد تهديد، بل قانوناً سارياً: من لم يُبايع جاع، ومن لم يخضع مات. ثم – بحمد الله – انتصر المحاصَر وانهزم المحاصِر!
تاريخ المجاعات في الإسلام: دروس من الماضي للحاضر
وفي تاريخنا الإسلامي، لم يكن الجوع مجرد حادثة تُسجَّل، بل تجربة حضارية تُختبَر بها عدالة السلطة، ونخوة الأمة، ومعدن الإنسان. ولعل خير من سجّل هذا المعنى في تراثنا هو المؤرخ تقي الدين المقريزي (ت 845هـ)، الذي أرّخ للمجاعات في مصر في كتابه (إغاثة الأمة بكشف الغمة)، وقد وقف بقلمه لا ليسجّل مآسي الناس فقط، بل ليدين فساد الحُكْم وظلم الجُباة وخراب المنظومة كلها، فقال: ’’وأما السبب الأعظم في ذلك الغلاء، فهو اختلال نظام الحُكْم، وتسلّط أرباب الجباية، وتمادي المفسدين في الأرض، مع تعطيل المعايش، واحتكار الأقوات‘‘. وكأنّه يتحدث عمّا يحدث هذه الأيام. فلم يكن الجوع عنده مجرّد شُحّ، بل نتيجة منطقية لسقوط السياسة، وامّحاء العدالة، وخراب الضمائر.
تاريخ الغوث والتخلي عن المسؤولية
لكنّ المجاعة في تراثنا لم تكن تمرّ بلا ضمير؛ فحين اجتاحت المجاعة المدينة المنورة في عام الرمادة، لم يكتف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالبكاء، بل امتنع عن أكل اللحم والسمن، واسودّ وجهه من الجوع، وقال قولته الخالدة:
’’كيف يشبع عمر، وأمته جياع؟ والله لا أذوق سمناً ولا لحماً حتى يشبع آخر طفل من أطفال المسلمين‘‘. ولم يكن في مواجهة المجاعة وحده! بل هبّت الأنصار من الشام ومصر والعراق وغيرها لتقديم ما تستطيع، ولم تتذرّع بالسيادة وحدود الجغرافيا، فهذه مصر تستنفر بكل نخوتها للغوث، فأرسلت قوافل القمح والسويق والزيت إلى المدينة، كما أقبلت القوافل من الشام واليمامة والبحرين والعراق، فكانت الأمة كالجسد الواحد. فحين استجابت الأمة استجاب الله؛ فانفرجت الكُربة، ونزل المطر، وزال القحط، وبقي عمر رضي الله عنه شاهداً على أنّ الإمام العادل خِصب الزمان.
التحول في القيم: من العطاء إلى الإهمال في عصر المجاعة
أما اليوم، فكم هي المفارقة موجعة! فلقد انقلبت المعادلة. من أمصار كانت تهبّ حين يناديها المستغيث، إلى أنظمةٍ تُغلق الأبواب في وجه المستغيثين. من نخوة تُكسر بها الحصارات، إلى صمتٍ يكسر ظهور الجائعين. من تاريخ كان يُسطَّر بالقمح المرسل من مصر والشام، إلى واقع تُخنق فيه المساعدات في المعابر.
فمصر الأمس كانت شريان الحياة في عام الرمادة، أصبحت – للأسف – حاجزاً منيعاً أمام الشاحنات، وأمست بوابة كانت تنبض بالغوث، تُدار اليوم كعصابة تمنع الغيث. وما ذلك إلا تحول في القيم، وانتكاس في الإيمان، وخيانة للتاريخ والمروءة. لقد علّمنا القرآن أن المجاعة ليست مجرّد قحطٍ، بل نتيجةٌ لصناعة البشر وظلمهم قال تعالى: ﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بما كانوا يصنعون﴾ [النحل: 112]. فـ’’لباس الجوع‘‘ ليس جوعاً بيولوجياً فحسب، بل هو مهانة كُليّة تلتصق بأمة لم تقم بدورها الحضاري وواجبها الأخلاقي.
الأخلاق في زمن الجوع: مسؤولية الفرد والمجتمع
إن الجوع امتحان حضاري، والردّ عليه هو ما يصنع الفرق بين أمة تُبتلى فتنجو، وأمة تُبتلى فتسقط. ولقد قالها القرآن صريحة لا غموض فيها: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [محمد: 38].
فالسنن لا تُجامل، ولا ترحم المتفرجين. لا تُبقي المتخاذلين، ولا تتأخر عن الشركاء في صناعة الجوع وتبريره.
فمن لم يُطعم، فليكتب. ومن لم يملك خبزًا، فليملك صوتًا.
ومن رأى طفلًا يموت جوعاً، ثم غيّر القناة، وأكمل طعامه، فقد شارك في موته، وإن لم يطلق عليه رصاصة. وقد عذر الله قوما عجزوا عن الإنفاق شفعت لهم دموعهم قال تعالى: ﴿تَوَلَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون﴾ [التوبة: 92]. هذا العذر لا يُمنَح إلا لمن بكى بصدق، وعجز بصدق. أما من امتلك ولم يُعطِ، أو شهد ولم يُبالِ، أو سمع ولم يتحرك، فلا عذر له عند الله، ولا نجاة له من سنن الاستبدال. ومن لا يغضب للجائع، لا يملك مؤهلات القيادة، ولا شرعية البقاء.
إن الحضارة لا تبدأ من حجارة تُبنى، بل من الرحمة التي تُبذل، من رغيف يُرسل، من كلمة تُكتب، من وقفة تُكسر بها حلقة الصمت. ولعل المقارنة الأكثر إيلاماً، أن الجاهلية الأولى سجلت مواقف أكثر شهامةً من بعض ’’إسلام‘‘ اليوم. ففي حصار بني هاشم، رغم شدته، لم تمت نخوة العرب. ولم تُسجّل كتب السيرة أن أحداً مات من الجوع، لأن ضمائر حية قالت:
’’لا نرضى أن نأكل، وبنو هاشم جياع!‘‘ فانكسرت الصحيفة، وسُرّبت المؤن، وارتفعت الأصوات في مكة على الرغم من كفرها، لترفض سياسة التجويع. أما اليوم، فلا أخوّة الإسلام نطقت، ولا نخوة العروبة انتفضت، ولا مروءة الفطرة بقيت!!
___________
أ.أحمد الحاجي: كاتب وباحث في السياسية الشرعية.
هذا المقال يُعَبِّرُ عن رأي كاتبه ولا يُعَبِّرُ بالضرورة عن رأي الموقع.

مركز_أمية_للبحوث_والدراسات_الاستراتيجية_مقالات_تاريخية_أحمد_الحاجي_قراءة_في_تاريخ_المجاعة_المجاعة_أقسى_صور_السقوط_الحضاري